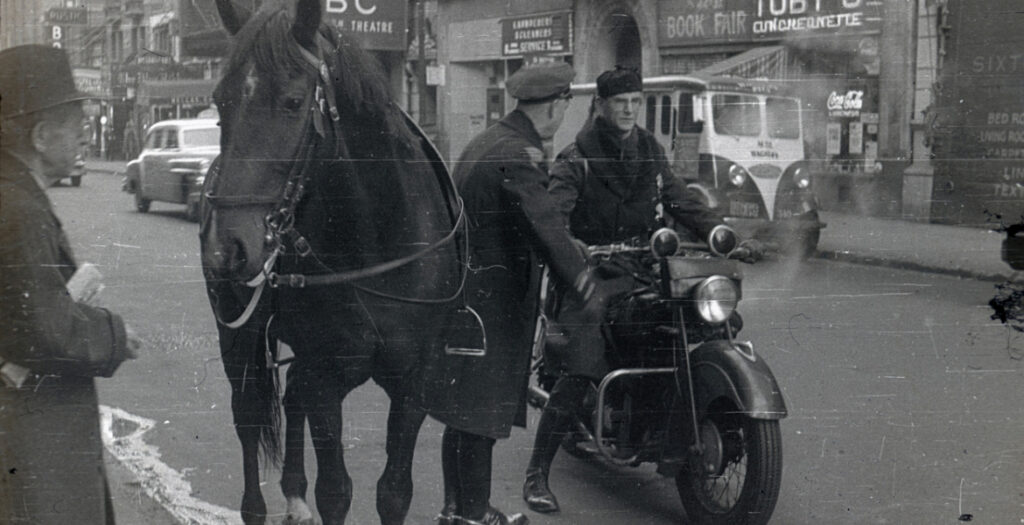اختتمت فعاليات مهرجان القدس للسينما العربية والتي امتدت من 14 وحتى 19 أيار بمشاركة 26 فيلمًا عربيًا من تونس ومصر والعراق والصومال والسعودية وسوريا ولبنان والجزائر والأردن وفلسطين، وبعدة ورش وفعاليات حول السينما، كما نُظمت وللمرة الأولى عروض لبعض أفلام المهرجان بالتزامن في بيروت من خلال شراكة مع دار النمر للفن والثقافة.
وأُعلن في حفل الختام الذي أقيم في المسرح الوطني الفلسطيني-الحكواتي في القدس، عن الأفلام الفائزة في مسابقة المهرجان، بعد تقييم لجنة من صنّاع ومخرجين ونقاد سينمائيين من فلسطين والوطن العربي، كما أعلن المهرجان عن إطلاق اسم الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة على جائزة الفيلم الوثائقي.
وجاءت الأفلام الفائزة كالتالي:
فئة الأفلام القصيرة، حاز الفيلم الصومالي “هل سيزورني والداي؟” للمخرج موه هاراوي، على جائزة أفضل فيلم قصير، أما الفيلم اللبناني “ثم يأتي الظلام” للمخرجة ماري – روز اسطا، فحاز على جائزة لجنة التحكيم للفيلم القصير، كما حاز كل من الفيلم المصري “خديجة” للمخرج مراد مصطفى، والفيلم اللبناني “الجدار” للمخرجة ميرا صيدواي على تنويه خاص.
أما في فئة الأفلام الوثائقية – جائزة شيرين أبو عاقلة، فحاز فيلم “من القاهرة” للمخرجة هالة جلال، على جائزة أفضل فيلم وثائقي، أما جائزة لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي فكانت من نصيب الفيلم اللبناني “إعادة تدمير” للمخرج سيمون الهبر.
وفي فئة الأفلام الروائية، نال الفيلم التونسي “قدحة” للمخرج أنيس الأسود على جائزة أفضل فيلم روائي، في حين حصل الفيلم العراقي “أوروبا” للمخرج حيدر رشيد على تنويه خاص.
وضمت لجنة تحكيم مسابقة المهرجان لفئة الفيلم الروائي الطويل، المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، رئيسة للجنة وبعضوية الناقد السينمائي والكاتب الصحفي المصري محمد سيد عبد الرحيم، والمبرمج ومنتج الأفلام السوداني طلال عفيفي. أما لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي، فضمت كل من المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة كرئيسة للجنة، وعضوية الصحافية ومعدة الأفلام الوثائقية اللبنانية بيسان طي، والمنتج الأردني بسام الأسعد. وترأست لجنة تحكيم للفيلم القصير، الأكاديمية والباحثة السينمائية التونسية إنصاف أوهيبة، وعضوية المخرج اللبناني كريم الرحباني، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية أميرة دياب.
وقالت مديرة المهرجان نيفين شاهين: “نفتخر بتنظيم النسخة الثانية للمهرجان في ظل ظروف استثنائية شهدتها فلسطين مع انطلاق المهرجان واستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومع ذلك رأينا أن السينما والصحافة يخدمان هدفا واحدا ورسالة إنسانية واحدة، لذا مضينا في تنظيم المهرجان، والذي يهدف لتعزيز مكانة القدس الثقافية، وتعزيز امتدادها مع محطيها العربي، إضافة إلى تعزيز العمل بالأدوات السينمائية بين فئة الشباب، من خلال عدة ورش حول كتابة السيناريو والنقد السينمائي والإخراج، نظمها المهرجان”.
وشهدت الورش الي نظمها المهرجان وهي “كتابة السيناريو: القدس في عام 2050″ مع المخرج والمنتج سليم أبو جبل، و”كتابة المقال: النقد السينمائي” مع الناقدة سماح بصول، حضورا لشباب من القدس، وحضورا رقميا لمشاركين من مختلف المناطق الفلسطينية ومن مصر والجزائر.
ونُظمت عروض المهرجان بالتعاون مع شركاء المهرجان الاستراتيجيين وهم: المسرح الوطني الفلسطيني- الحكواتي، والمركز الثقافي الفرنسي في القدس، والمركز الثقافي التركي “يونس أمره” في القدس، وبدعم من عدة مؤسسات دولية وشركات قطاع خاص فلسطينية، تثني إدارة المهرجان على دورهم الهام.
ويطمح القائمون على المهرجان أن يتحول من مبادرة ثقافية إلى كيان ثقافي مستقل ينطلق من قلب مدينة القدس.